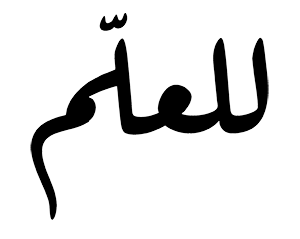كيف تُشكل الجينات التنظيمية مصير مؤسستك؟
مثلما تمتلك الكائنات الحية جينات تُحدد خصائصها ووظائفها الأساسية، تمتلك المؤسسات ما يمكن أن نُطلق عليه الجينات التنظيمية؛ هذه الجينات ليست هياكل مادية، بل هي مجموعة من القيم الجوهرية، والمعتقدات الراسخة، والقواعد غير المكتوبة، والعمليات الإجرائية المترسخة التي تُشكل الحمض النووي (DNA) لسلوك المؤسسة وهويتها وثقافتها ومناخها التنظيمي السائد. فهي القوى الخفية التي تُملي كيفية اتخاذ القرارات على كافة المستويات، وكيفية تفاعل الفريق مع بعضهم البعض ومع المستفيدين من الخدمة، وما هي الأولويات التي تُوجه توزيع الموارد والجهود. وهذه الجينات هي التي تُفسر سبب تصرف مؤسستين في نفس القطاع بشكل مختلف تمامًا عند مواجهة تحدٍ مماثل. فهم هذه الجينات التنظيمية وتحليلها يُمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق التغيير المستدام والمرونة الاستراتيجية، فالأداء الظاهري للمؤسسة هو مجرد نتاج لتفاعل هذه الجينات العميقة والمترسخة التي غالبًا ما تتجاوز حدود الهيكل التنظيمي الرسمي.
تتجلى الجينات التنظيمية في عدة مستويات داخل المؤسسة، بدءًا من ثقافة العمل اليومية ووصولًا إلى آليات الحوكمة العليا. ففي جوهرها، تُمثل هذه الجينات المعتقدات الأساسية التي يتقاسمها أعضاء المنظمة، والتي غالبًا ما تكون غير واعية أو غير مُوثقة رسميًا في أدلة العمل. على سبيل المثال، قد يكون الجين السائد في إحدى المؤسسات هو تجنب المخاطر والبحث عن الكمال المفرط قبل الإطلاق، مما يؤدي إلى عمليات موافقة بطيئة وبيروقراطية، وتأخير في طرح المنتجات في السوق، حتى لو كانت ذات جودة عالية. هذا الجين يُعزز الاستقرار، ولكنه يخنق الابتكار. في المقابل، قد يكون الجين في مؤسسة منافسة هو السرعة في الإنجاز والتعلم التكراري من الفشل، مما يُنتج بيئة مُتجددة وقادرة على الاستجابة السريعة للسوق، ولكنها قد تفتقر إلى الانضباط الصارم في بعض الأحيان. هذه التوليفة الجينية هي التي تُحدد هوية المؤسسة في نظر أصحاب المصلحة؛ فما إذا كانت تُعرف بالابتكار الجريء أو بالموثوقية المحافظة يعتمد بشكل حاسم على تركيبتها الجينية الداخلية المتراكمة عبر تاريخها.
تُصبح هذه الجينات مؤثرة بشكل خاص عند وقوع المنظمة تحت الضغوط الخارجية الشديدة أو أثناء فترات الأزمات غير المتوقعة. في هذه الأوقات الحرجة، يتراجع السلوك الرسمي الموثق في الدلائل الإرشادية، ويبرز السلوك الغريزي المدفوع بالجينات التنظيمية المتأصلة. المؤسسات التي تمتلك جينات الشفافية الجذرية والتواصل المفتوح ثنائي الاتجاه غالبًا ما تتجاوز الأزمات بتماسك أكبر، حيث يشعر العاملون بالثقة ويتبنون المسؤولية المشتركة عن حل المشكلة. وعلى النقيض، فإن المنظمات التي ورثت جينات المركزية الشديدة في اتخاذ القرار والخوف من مشاركة المعلومات تميل إلى الانغلاق والجمود، مما يُعيق عملية اتخاذ القرار السريع والتفويض الفعال اللازمين للنجاة من الأزمة. هذه الجينات تُحدد أيضًا طريقة تعامل المنظمة مع الكفاءات: هل جين المؤسسة هو مكافأة الأفراد الموهوبين حتى لو كانوا مُثيرين للتحدي، أم تفضيل الأفراد المُطيعين حتى لو كانوا أقل كفاءة؟ الإجابة على هذا السؤال تُحدد مسار النمو المستقبلي للمنظمة.
إن محاولات التغيير التنظيمي التي تقوم بها الإدارة العليا غالبًا ما تفشل لأنها تُركز فقط على تغيير المظهر: مثل إعادة رسم الهيكل التنظيمي أو تطبيق نظام تخطيط موارد مؤسسات جديد دون معالجة الجينات الأساسية الكامنة وراءها. لا يمكن تغيير ثقافة تجنب المخاطر بمجرد الإعلان عن مبادرة تشجيع الابتكار في مذكرة داخلية. يجب أولًا إعادة برمجة الجين التنظيمي عن طريق تغيير مصفوفة المكافآت والعقوبات الفعلية، وتعديل سلوك القادة ليصبحوا نماذج يحتذى بها في المخاطرة المحسوبة، وتوفير المساحة الآمنة للاعتراف بالفشل والتعلم منه دون خوف من العقاب. بعبارة أخرى، يجب على الإدارة أن تُنشئ بيئة يصبح فيها السلوك الجديد هو السلوك الطبيعي والمُتوقع، وليس مجرد استثناء يتم فرضه من الأعلى.
هذا المفهوم يتجاوز الثقافة العامة ليطال العمليات التشغيلية الأساسية والعلاقات البينية بين الأقسام. فـجين التعاون بين الإدارات يظهر في مدى سهولة تبادل البيانات والموارد بين فريق التسويق وفريق المبيعات دون المرور بإجراءات طلبات معقدة تستغرق أسابيع. وجين التركيز على العميل لا يتمثل فقط في شعار معلق على الحائط، بل في التفاصيل الدقيقة لكيفية تصميم نقاط الاتصال مع العملاء، وكيفية تخصيص الموارد المالية للخدمات اللوجستية مقارنة بالاستثمار في البحث والتطوير. إن نجاح عملية الاندماج والاستحواذ، على سبيل المثال، يعتمد بشكل حاسم على مدى توافق أو صراع الجينات التنظيمية للمنظمتين المندمجتين. إذا كانت إحداهما سريعة وغير رسمية والأخرى بطيئة وبيروقراطية، فإن دمج الهياكل وحده لن ينجح؛ يجب تصميم عملية دمج ثقافي وجيني حقيقية مُركزة تبدأ من اليوم الأول.
لإدارة الجينات التنظيمية بفعالية، يجب على القيادة أن تتحول إلى مهندسي جينات بدلاً من مجرد مديري عمليات. هذا يتطلب تحليلًا تشخيصيًا عميقًا لكيفية عمل المنظمة بالفعل – وليس كيف يفترض أن تعمل وفقًا للوصف الوظيفي – وتحديد الجينات التي تُعزز الفعالية والكفاءة وتلك التي تُسبب الخلل المؤسسي. بعد ذلك، يتم تطبيق تدخّلات مُستهدفة، مثل: تغيير نمط تعيين الموظفين الجدد لضخ دماء تحمل جينات مرغوبة مثل الفضول والمساءلة، أو تصميم تجارب داخلية مختبرات تُجبر الفرق على تبني سلوكيات جديدة في بيئة آمنة، ومن ثم ترسيخ هذه السلوكيات الجديدة لتتحول إلى عادات مؤسسية، أو جينات مُعدّلة. هذا النهج يضمن أن التغيير لا يقتصر على الواجهة، بل يتغلغل في صميم المنظمة.
في الختام، تُشكل الجينات التنظيمية القوة الدافعة الحقيقية الكامنة وراء أداء المؤسسات واستدامتها وقدرتها على تحقيق الأهداف الاستراتيجية. إنها تُفسر لماذا تنجح بعض الاستراتيجيات في منظمة وتفشل فشلًا ذريعًا في أخرى، ولماذا تظل بعض المشكلات الإجرائية مُزمنة على الرغم من الجهود الإصلاحية المتكررة. الذكاء التنظيمي الحقيقي يكمن في القدرة على قراءة هذا الحمض النووي المعقد للمؤسسة، والاعتراف بأن التغيير الهيكلي أو التكنولوجي هو مجرد غلاف خارجي لا يدوم طويلاً. إن التغيير العميق والدائم لا يحدث إلا عندما يتم تعديل أو إعادة برمجة هذه الجينات التنظيمية الأساسية. يجب على قادة اليوم أن يُركزوا جهودهم على بناء مرونة جينية تمكن مؤسساتهم من التكيف السريع مع تحديات الغد غير المتوقعة، مُدركين أن إرثهم الحقيقي لن يكون في الأرباح المُحققة فحسب، بل في جودة البصمة الجينية التنظيمية التي يتركونها لخلفائهم، مما يضمن بقاء المؤسسة وتطورها على المدى الطويل.
مثلما تمتلك الكائنات الحية جينات تُحدد خصائصها ووظائفها الأساسية، تمتلك المؤسسات ما يمكن أن نُطلق عليه الجينات التنظيمية؛ هذه الجينات ليست هياكل مادية، بل هي مجموعة من القيم الجوهرية، والمعتقدات الراسخة، والقواعد غير المكتوبة، والعمليات الإجرائية المترسخة التي تُشكل الحمض النووي (DNA) لسلوك المؤسسة وهويتها وثقافتها ومناخها التنظيمي السائد. فهي القوى الخفية التي تُملي كيفية اتخاذ القرارات على كافة المستويات، وكيفية تفاعل الفريق مع بعضهم البعض ومع المستفيدين من الخدمة، وما هي الأولويات التي تُوجه توزيع الموارد والجهود. وهذه الجينات هي التي تُفسر سبب تصرف مؤسستين في نفس القطاع بشكل مختلف تمامًا عند مواجهة تحدٍ مماثل. فهم هذه الجينات التنظيمية وتحليلها يُمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق التغيير المستدام والمرونة الاستراتيجية، فالأداء الظاهري للمؤسسة هو مجرد نتاج لتفاعل هذه الجينات العميقة والمترسخة التي غالبًا ما تتجاوز حدود الهيكل التنظيمي الرسمي.
تتجلى الجينات التنظيمية في عدة مستويات داخل المؤسسة، بدءًا من ثقافة العمل اليومية ووصولًا إلى آليات الحوكمة العليا. ففي جوهرها، تُمثل هذه الجينات المعتقدات الأساسية التي يتقاسمها أعضاء المنظمة، والتي غالبًا ما تكون غير واعية أو غير مُوثقة رسميًا في أدلة العمل. على سبيل المثال، قد يكون الجين السائد في إحدى المؤسسات هو تجنب المخاطر والبحث عن الكمال المفرط قبل الإطلاق، مما يؤدي إلى عمليات موافقة بطيئة وبيروقراطية، وتأخير في طرح المنتجات في السوق، حتى لو كانت ذات جودة عالية. هذا الجين يُعزز الاستقرار، ولكنه يخنق الابتكار. في المقابل، قد يكون الجين في مؤسسة منافسة هو السرعة في الإنجاز والتعلم التكراري من الفشل، مما يُنتج بيئة مُتجددة وقادرة على الاستجابة السريعة للسوق، ولكنها قد تفتقر إلى الانضباط الصارم في بعض الأحيان. هذه التوليفة الجينية هي التي تُحدد هوية المؤسسة في نظر أصحاب المصلحة؛ فما إذا كانت تُعرف بالابتكار الجريء أو بالموثوقية المحافظة يعتمد بشكل حاسم على تركيبتها الجينية الداخلية المتراكمة عبر تاريخها.
تُصبح هذه الجينات مؤثرة بشكل خاص عند وقوع المنظمة تحت الضغوط الخارجية الشديدة أو أثناء فترات الأزمات غير المتوقعة. في هذه الأوقات الحرجة، يتراجع السلوك الرسمي الموثق في الدلائل الإرشادية، ويبرز السلوك الغريزي المدفوع بالجينات التنظيمية المتأصلة. المؤسسات التي تمتلك جينات الشفافية الجذرية والتواصل المفتوح ثنائي الاتجاه غالبًا ما تتجاوز الأزمات بتماسك أكبر، حيث يشعر العاملون بالثقة ويتبنون المسؤولية المشتركة عن حل المشكلة. وعلى النقيض، فإن المنظمات التي ورثت جينات المركزية الشديدة في اتخاذ القرار والخوف من مشاركة المعلومات تميل إلى الانغلاق والجمود، مما يُعيق عملية اتخاذ القرار السريع والتفويض الفعال اللازمين للنجاة من الأزمة. هذه الجينات تُحدد أيضًا طريقة تعامل المنظمة مع الكفاءات: هل جين المؤسسة هو مكافأة الأفراد الموهوبين حتى لو كانوا مُثيرين للتحدي، أم تفضيل الأفراد المُطيعين حتى لو كانوا أقل كفاءة؟ الإجابة على هذا السؤال تُحدد مسار النمو المستقبلي للمنظمة.
إن محاولات التغيير التنظيمي التي تقوم بها الإدارة العليا غالبًا ما تفشل لأنها تُركز فقط على تغيير المظهر: مثل إعادة رسم الهيكل التنظيمي أو تطبيق نظام تخطيط موارد مؤسسات جديد دون معالجة الجينات الأساسية الكامنة وراءها. لا يمكن تغيير ثقافة تجنب المخاطر بمجرد الإعلان عن مبادرة تشجيع الابتكار في مذكرة داخلية. يجب أولًا إعادة برمجة الجين التنظيمي عن طريق تغيير مصفوفة المكافآت والعقوبات الفعلية، وتعديل سلوك القادة ليصبحوا نماذج يحتذى بها في المخاطرة المحسوبة، وتوفير المساحة الآمنة للاعتراف بالفشل والتعلم منه دون خوف من العقاب. بعبارة أخرى، يجب على الإدارة أن تُنشئ بيئة يصبح فيها السلوك الجديد هو السلوك الطبيعي والمُتوقع، وليس مجرد استثناء يتم فرضه من الأعلى.
هذا المفهوم يتجاوز الثقافة العامة ليطال العمليات التشغيلية الأساسية والعلاقات البينية بين الأقسام. فـجين التعاون بين الإدارات يظهر في مدى سهولة تبادل البيانات والموارد بين فريق التسويق وفريق المبيعات دون المرور بإجراءات طلبات معقدة تستغرق أسابيع. وجين التركيز على العميل لا يتمثل فقط في شعار معلق على الحائط، بل في التفاصيل الدقيقة لكيفية تصميم نقاط الاتصال مع العملاء، وكيفية تخصيص الموارد المالية للخدمات اللوجستية مقارنة بالاستثمار في البحث والتطوير. إن نجاح عملية الاندماج والاستحواذ، على سبيل المثال، يعتمد بشكل حاسم على مدى توافق أو صراع الجينات التنظيمية للمنظمتين المندمجتين. إذا كانت إحداهما سريعة وغير رسمية والأخرى بطيئة وبيروقراطية، فإن دمج الهياكل وحده لن ينجح؛ يجب تصميم عملية دمج ثقافي وجيني حقيقية مُركزة تبدأ من اليوم الأول.
لإدارة الجينات التنظيمية بفعالية، يجب على القيادة أن تتحول إلى مهندسي جينات بدلاً من مجرد مديري عمليات. هذا يتطلب تحليلًا تشخيصيًا عميقًا لكيفية عمل المنظمة بالفعل – وليس كيف يفترض أن تعمل وفقًا للوصف الوظيفي – وتحديد الجينات التي تُعزز الفعالية والكفاءة وتلك التي تُسبب الخلل المؤسسي. بعد ذلك، يتم تطبيق تدخّلات مُستهدفة، مثل: تغيير نمط تعيين الموظفين الجدد لضخ دماء تحمل جينات مرغوبة مثل الفضول والمساءلة، أو تصميم تجارب داخلية مختبرات تُجبر الفرق على تبني سلوكيات جديدة في بيئة آمنة، ومن ثم ترسيخ هذه السلوكيات الجديدة لتتحول إلى عادات مؤسسية، أو جينات مُعدّلة. هذا النهج يضمن أن التغيير لا يقتصر على الواجهة، بل يتغلغل في صميم المنظمة.
في الختام، تُشكل الجينات التنظيمية القوة الدافعة الحقيقية الكامنة وراء أداء المؤسسات واستدامتها وقدرتها على تحقيق الأهداف الاستراتيجية. إنها تُفسر لماذا تنجح بعض الاستراتيجيات في منظمة وتفشل فشلًا ذريعًا في أخرى، ولماذا تظل بعض المشكلات الإجرائية مُزمنة على الرغم من الجهود الإصلاحية المتكررة. الذكاء التنظيمي الحقيقي يكمن في القدرة على قراءة هذا الحمض النووي المعقد للمؤسسة، والاعتراف بأن التغيير الهيكلي أو التكنولوجي هو مجرد غلاف خارجي لا يدوم طويلاً. إن التغيير العميق والدائم لا يحدث إلا عندما يتم تعديل أو إعادة برمجة هذه الجينات التنظيمية الأساسية. يجب على قادة اليوم أن يُركزوا جهودهم على بناء مرونة جينية تمكن مؤسساتهم من التكيف السريع مع تحديات الغد غير المتوقعة، مُدركين أن إرثهم الحقيقي لن يكون في الأرباح المُحققة فحسب، بل في جودة البصمة الجينية التنظيمية التي يتركونها لخلفائهم، مما يضمن بقاء المؤسسة وتطورها على المدى الطويل.