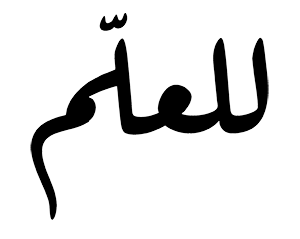الحل بكالوريوس 3 سنوات .. لنبدأ في تخصصات تكنولوجيا المعلومات
منذ عقود ارتبطت درجة البكالوريوس في الجامعات العربية، ومنها الجامعات الأردنية، بمدة زمنية ثابتة تقارب الأربع سنوات، يقوم الطالب خلالها بدراسة مزيج من المواد التخصصية والعامة التي يُفترض أن تصقل شخصيته وتبني مهاراته ومعارفه. غير أن هذا النموذج، الذي ربما كان مناسبًا في الماضي، يثير اليوم أسئلة عميقة حول مدى صلاحيته لتخصصات سريعة التغير مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعلوم البيانات وسائر فروع تكنولوجيا المعلومات.
فالطالب الذي يدخل الجامعة في سن الثامنة عشرة ليبدأ رحلة دراسية تمتد لأربع سنوات، قد يجد أن ما تعلمه في عامه الأول أصبح قديمًا عند تخرجه. التكنولوجيا لا تنتظر، والمناهج التي تُبنى على أساس الاستقرار والثبات تفقد جزءًا كبيرًا من قيمتها في بيئة يتسارع فيها التطور بوتيرة مذهلة. إننا نعيش عصرًا تتحول فيه البرمجيات والأدوات والمنصات بين عشية وضحاها، ومن الظلم أن نحكم على الطالب أن يقضي سنوات طويلة في قاعة الدرس قبل أن تتهيأ له فرصة حقيقية للاحتكاك المباشر بسوق العمل.
النماذج العالمية تقدم شواهد مهمة على إمكانية تجاوز هذا الجمود. ففي بريطانيا مثلًا، يحصل الطالب على البكالوريوس خلال ثلاث سنوات فقط، حيث يندمج في التخصص منذ اليوم الأول وتقتصر المواد العامة على الحد الأدنى. وفي أستراليا تسير الجامعات على النهج ذاته، إذ يكمل الطالب دراسته في ثلاث سنوات، مع خيار تمديدها إلى أربع إذا أراد التعمق في مشروع بحثي أو نيل درجة الشرف. هذه التجارب أثبتت أن اختصار المدة لا ينتقص من القيمة الأكاديمية، بل يمنح الطالب سرعة الوصول إلى سوق العمل، ويتيح له لاحقًا استكمال دراساته العليا أو الحصول على شهادات احترافية معترف بها عالميًا.
أما في الأردن ومعظم الدول العربية، فما زال النظام قائماً على أربع سنوات، بمتطلبات تصل إلى 136 ساعة معتمدة تشمل مواد ثقافة عامة، ولغات، وتربية وطنية، إلى جانب مواد التخصص. صحيح أن لهذه المواد في الماضي دورًا في بناء شخصية الطالب وإكسابه أبعادًا إنسانية وثقافية، إلا أنها في عصر السرعة قد تحولت إلى عبء يستهلك وقتًا وجهدًا كان من الممكن أن يُستثمر في مهارات عملية مباشرة يحتاجها الخريج في حياته المهنية.
التصور الأكثر واقعية اليوم هو أن تُعاد هندسة الخطط الدراسية لهذه التخصصات لتصبح أكثر كثافة ومرونة. ثلاث سنوات قد تكون كافية إذا صُممت الخطة بحيث يدخل الطالب إلى عمق التخصص منذ البداية، ويُدمج التدريب العملي في مسار الدراسة ليكون جزءًا أصيلًا من تجربته الأكاديمية. فبدل أن يظل التدريب خيارًا ثانويًا أو نشاطًا صيفيًا، يمكن أن يصبح فصلًا دراسيًا كاملًا يقضيه الطالب في شركة تقنية أو مؤسسة متخصصة، ليعود بعدها وقد اكتسب خبرة حقيقية تُضاف إلى رصيده.
الجامعات قادرة على التكيف، والطالب أكثر قدرة على الإنجاز مما نظن، وسوق العمل في أمس الحاجة إلى كفاءات تدخل الميدان بسرعة وتواكب أحدث التقنيات. أما الإصرار على إبقاء المدة أربع سنوات دون مراجعة، فهو أقرب إلى تقليد جامد لا يخدم مصلحة أحد. فالعالم يتغير بسرعة، ومناهجنا ينبغي أن تتغير معه، لا أن تبقى محكومة بمنطق الأمس.
لقد آن الأوان أن تتحلى الجامعات بجرأة إعادة النظر، وأن تبتكر برامج حديثة تجمع بين العمق الأكاديمي والسرعة في الإنجاز، وأن تمنح الطالب الفرصة ليصبح فاعلًا في السوق بأسرع وقت ممكن، دون أن يُحاصر في قاعات طويلة الانتظار. إن تقليص مدة دراسة تخصصات تكنولوجيا المعلومات ليس تقليلاً من شأن العلم ولا انتقاصًا من قيمة الدرجة الجامعية، بل هو اعتراف بأن المعرفة في هذه الحقول لا تُختزن في الكتب وحدها، وإنما تُبنى في الممارسة والتجربة والتدريب المستمر.
إن مسؤولية الجامعات أن تجهز طلابها لعصرهم، لا أن تبقيهم أسرى ماضي المناهج البطيئة. وحين نُعيد النظر في مدة الدراسة وبرامجها، فإننا لا نغير شكلاً إداريًا فقط، بل نعيد صياغة علاقة الجامعة بالحياة، ونمنح أبناءنا فرصة العيش في زمنهم لا في زمن مضى.
فالطالب الذي يدخل الجامعة في سن الثامنة عشرة ليبدأ رحلة دراسية تمتد لأربع سنوات، قد يجد أن ما تعلمه في عامه الأول أصبح قديمًا عند تخرجه. التكنولوجيا لا تنتظر، والمناهج التي تُبنى على أساس الاستقرار والثبات تفقد جزءًا كبيرًا من قيمتها في بيئة يتسارع فيها التطور بوتيرة مذهلة. إننا نعيش عصرًا تتحول فيه البرمجيات والأدوات والمنصات بين عشية وضحاها، ومن الظلم أن نحكم على الطالب أن يقضي سنوات طويلة في قاعة الدرس قبل أن تتهيأ له فرصة حقيقية للاحتكاك المباشر بسوق العمل.
النماذج العالمية تقدم شواهد مهمة على إمكانية تجاوز هذا الجمود. ففي بريطانيا مثلًا، يحصل الطالب على البكالوريوس خلال ثلاث سنوات فقط، حيث يندمج في التخصص منذ اليوم الأول وتقتصر المواد العامة على الحد الأدنى. وفي أستراليا تسير الجامعات على النهج ذاته، إذ يكمل الطالب دراسته في ثلاث سنوات، مع خيار تمديدها إلى أربع إذا أراد التعمق في مشروع بحثي أو نيل درجة الشرف. هذه التجارب أثبتت أن اختصار المدة لا ينتقص من القيمة الأكاديمية، بل يمنح الطالب سرعة الوصول إلى سوق العمل، ويتيح له لاحقًا استكمال دراساته العليا أو الحصول على شهادات احترافية معترف بها عالميًا.
أما في الأردن ومعظم الدول العربية، فما زال النظام قائماً على أربع سنوات، بمتطلبات تصل إلى 136 ساعة معتمدة تشمل مواد ثقافة عامة، ولغات، وتربية وطنية، إلى جانب مواد التخصص. صحيح أن لهذه المواد في الماضي دورًا في بناء شخصية الطالب وإكسابه أبعادًا إنسانية وثقافية، إلا أنها في عصر السرعة قد تحولت إلى عبء يستهلك وقتًا وجهدًا كان من الممكن أن يُستثمر في مهارات عملية مباشرة يحتاجها الخريج في حياته المهنية.
التصور الأكثر واقعية اليوم هو أن تُعاد هندسة الخطط الدراسية لهذه التخصصات لتصبح أكثر كثافة ومرونة. ثلاث سنوات قد تكون كافية إذا صُممت الخطة بحيث يدخل الطالب إلى عمق التخصص منذ البداية، ويُدمج التدريب العملي في مسار الدراسة ليكون جزءًا أصيلًا من تجربته الأكاديمية. فبدل أن يظل التدريب خيارًا ثانويًا أو نشاطًا صيفيًا، يمكن أن يصبح فصلًا دراسيًا كاملًا يقضيه الطالب في شركة تقنية أو مؤسسة متخصصة، ليعود بعدها وقد اكتسب خبرة حقيقية تُضاف إلى رصيده.
الجامعات قادرة على التكيف، والطالب أكثر قدرة على الإنجاز مما نظن، وسوق العمل في أمس الحاجة إلى كفاءات تدخل الميدان بسرعة وتواكب أحدث التقنيات. أما الإصرار على إبقاء المدة أربع سنوات دون مراجعة، فهو أقرب إلى تقليد جامد لا يخدم مصلحة أحد. فالعالم يتغير بسرعة، ومناهجنا ينبغي أن تتغير معه، لا أن تبقى محكومة بمنطق الأمس.
لقد آن الأوان أن تتحلى الجامعات بجرأة إعادة النظر، وأن تبتكر برامج حديثة تجمع بين العمق الأكاديمي والسرعة في الإنجاز، وأن تمنح الطالب الفرصة ليصبح فاعلًا في السوق بأسرع وقت ممكن، دون أن يُحاصر في قاعات طويلة الانتظار. إن تقليص مدة دراسة تخصصات تكنولوجيا المعلومات ليس تقليلاً من شأن العلم ولا انتقاصًا من قيمة الدرجة الجامعية، بل هو اعتراف بأن المعرفة في هذه الحقول لا تُختزن في الكتب وحدها، وإنما تُبنى في الممارسة والتجربة والتدريب المستمر.
إن مسؤولية الجامعات أن تجهز طلابها لعصرهم، لا أن تبقيهم أسرى ماضي المناهج البطيئة. وحين نُعيد النظر في مدة الدراسة وبرامجها، فإننا لا نغير شكلاً إداريًا فقط، بل نعيد صياغة علاقة الجامعة بالحياة، ونمنح أبناءنا فرصة العيش في زمنهم لا في زمن مضى.