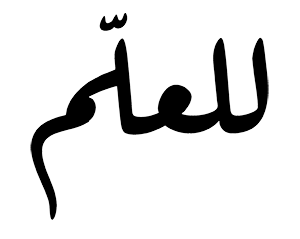الدين العام: ضرورة الفهم قبل الحكم
ملف الدين العام يشكل تحديًا مستمرًا للاقتصاد الأردني، لكنه أيضًا أداة ضرورية لإدارة المالية العامة إذا ما تم التعامل معه بحكمة. الحلول الممكنة لإدارة الدين تتمثل في ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، ضبط الإنفاق الجاري؛ ثانيًا، تحفيز النمو الاقتصادي لتعزيز الإيرادات؛ وثالثًا، تنويع أدوات الدين واستبدال الديون مرتفعة الفائدة بأخرى منخفضة. هذه المحاورمن المفترض أن تشكل الإطار الاستراتيجي لإدارة الدين بشكل فعال وتحقيق استدامة مالية واقتصادية، لذلك نذكر مجدداً بأهمية وجود استراتيجية لإدارة الدين العام!
خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، ارتفع الدين العام بمقدار 2.688 مليار دينار، وهو رقم أثار جدلاً واسعًا بين من يعتبر الدين مبررًا لتغطية الاحتياجات التمويلية ومن يراه مقلقًا. لكن لفهم الصورة الحقيقية، يجب قراءة هذا التطور في سياق الأداء المالي العام للدولة. فإجمالي الإنفاق خلال هذه الفترة بلغ نحو 7.795 مليار دينار (31% من الناتج المحلي) بمتوسط شهري 974.4 مليون دينار، في حين وصلت الإيرادات المحلية إلى 6.194 مليار دينار (24% من الناتج المحلي)، بمتوسط شهري يقارب 774.3 مليون دينار. وبذلك، بلغ العجز المالي الشهري نحو 200.1 مليون دينار شهرياً وحوالي 1.6 ملياردينارخلال تلك الفترة (6.4% من الناتج المحلي)، مع انخفاض المنح الخارجية بنسبة 61.9% لتسجل 30.2 مليون دينار فقط.
الملاحظة الأولى، وبرغم تراجع المنح، أظهرت الإيرادات المحلية تحسنًا إلى 6.194 مليار دينار مقابل 5.972 مليار دينار في 2024، بزيادة 257.4 مليون دينار. هذا التحسن يعكس كفاءة أعلى في التحصيل الضريبي، خصوصًا في ضريبة المبيعات التي ارتفعت مقابل تراجع ضريبة الدخل نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل عام. ارتفاع الإيرادات المحلية ساعد على تعويض تراجع المنح والحفاظ على استقرار الأداء المالي، كما أدى إلى تحسن نسبة الاعتماد على الذات (الإيرادات المحلية إلى الإنفاق الجاري) من 84.9% إلى 87.6%.
ثاني الملاحظات، الارتفاع في الإنفاق كان محدودًا، حيث زادت النفقات الجارية بنسبة 6.3% لتصل إلى 7.069 مليار دينار، بينما ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 13.5% لتبلغ 725.6 مليون دينار. هذا يعكس التركيز على الإنفاق المنتج الذي يدعم النمو الاقتصادي، بدلًا من توسع كبير في الإنفاق التشغيلي. لكن تلك النفقات تتطلب وضوحاً أكبر في وجهة هذا الإنفاق والقطاعات التي استفادت منه. ومع عدم وجود تدفق استثماري يغطي كامل النفقات الرأسمالية، يصبح الاقتراض ضرورة اقتصادية وليس خيارًا ترفيهيًا، شرط أن يُدار بكفاءة.
الملاحظة الثالثة، أن تنويع أدوات الدين مهم وسيساهم بتخفيف تكلفة خدمة الالتزامات المالية. حيث تم تسديد سندات اليوروبوند المستحقة عبر تمويل ميسر من بعض الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى إصدار أدوات مالية جديدة مثل الصكوك الإسلامية لاستثمار فائض السيولة لدى البنوك الإسلامية وتوفير بدائل تمويلية منخفضة الفائدة. هذه الخطوات تساعد على استدامة الدين وتحسين إدارة الالتزامات المالية الحكومية.
تحليل أرقام المالية العامة يظهر صورة قد تبدو مختلفة قليلةً، من حيث الالتزام بعدة محاور رئيسية: أولًا، ضبط النفقات الجارية حيث سجلت زيادة منخفضة حوالي 6%، وهو مؤشر إيجابي على السيطرة المالية؛ ثانيًا، تحفيز النمو الاقتصادي، إذ أظهرت الأرقام نموًا نسبيًا بلغ 2.7% في الربع الأول و2.8% في الربع الثاني نتيجة سلسلة قرارات تحفيزية انعكست على زيادة الإيرادات وتقليل العجز؛ ثالثًا، تنويع أدوات الدين لتقليل تكلفة التمويل وتحسين الإدارة المالية. واذا ما استمر هذا السياق في إدارة الدين سينعكس بصورة ايجابية على خفض مستوياته كنسبة من الناتج حتى إن أظهر ارتفاعاً مؤقتاً بفترة من الفترات.
مرة أخرى نؤكد على أن الدين العام ليس مشكلة بحد ذاته إذا ما تم استخدامه وفقاً للأس العلمية وضمن منهجية محكمة تركزعلى تحفيز النمو الاقتصادي وتراعي مبادىء الاستدامة المالية، لكن غياب الشفافية والاستراتيجية الواضحة هو ما يثير القلق. فالاقتراض أداة اقتصادية ضرورية في ظل اختلالات الاقتصاد الإقليمي والعالمي، شرط أن يُدار بذكاء لتحقيق أهداف محددة: دعم النمو، تحسين الكفاءة، وضمان الاستدامة المالية. فالفرق كبير وجوهري هو بين من يقترض لتعزيز إدارة الإنفاق والنمو، ومن يقترض بلا رؤية لتغطية النفقات الجارية وخدمة الدين.
إن الفهم الاقتصادي المتكامل للدين العام هو الركن الأساسي في المعادلة، والذي يأخذ في الاعتبار النمو، الكفاءة، والاستدامة، لذلك هو الخطوة الأساسية للحكم العادل على السياسات المالية. الأرقام وحدها لا تكفي، بل يجب النظر إلى ما وراءها: كيف يُدار الدين؟ هل يساهم في التنمية الاقتصادية؟ وهل يضمن استدامة المالية العامة؟ الخروج من جدلية "من الأكثر اقتراضًا" إلى الحديث عن "فاعلية الاقتراض" هو ما يحتاجه الاقتصاد الأردني اليوم.
خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، ارتفع الدين العام بمقدار 2.688 مليار دينار، وهو رقم أثار جدلاً واسعًا بين من يعتبر الدين مبررًا لتغطية الاحتياجات التمويلية ومن يراه مقلقًا. لكن لفهم الصورة الحقيقية، يجب قراءة هذا التطور في سياق الأداء المالي العام للدولة. فإجمالي الإنفاق خلال هذه الفترة بلغ نحو 7.795 مليار دينار (31% من الناتج المحلي) بمتوسط شهري 974.4 مليون دينار، في حين وصلت الإيرادات المحلية إلى 6.194 مليار دينار (24% من الناتج المحلي)، بمتوسط شهري يقارب 774.3 مليون دينار. وبذلك، بلغ العجز المالي الشهري نحو 200.1 مليون دينار شهرياً وحوالي 1.6 ملياردينارخلال تلك الفترة (6.4% من الناتج المحلي)، مع انخفاض المنح الخارجية بنسبة 61.9% لتسجل 30.2 مليون دينار فقط.
الملاحظة الأولى، وبرغم تراجع المنح، أظهرت الإيرادات المحلية تحسنًا إلى 6.194 مليار دينار مقابل 5.972 مليار دينار في 2024، بزيادة 257.4 مليون دينار. هذا التحسن يعكس كفاءة أعلى في التحصيل الضريبي، خصوصًا في ضريبة المبيعات التي ارتفعت مقابل تراجع ضريبة الدخل نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل عام. ارتفاع الإيرادات المحلية ساعد على تعويض تراجع المنح والحفاظ على استقرار الأداء المالي، كما أدى إلى تحسن نسبة الاعتماد على الذات (الإيرادات المحلية إلى الإنفاق الجاري) من 84.9% إلى 87.6%.
ثاني الملاحظات، الارتفاع في الإنفاق كان محدودًا، حيث زادت النفقات الجارية بنسبة 6.3% لتصل إلى 7.069 مليار دينار، بينما ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 13.5% لتبلغ 725.6 مليون دينار. هذا يعكس التركيز على الإنفاق المنتج الذي يدعم النمو الاقتصادي، بدلًا من توسع كبير في الإنفاق التشغيلي. لكن تلك النفقات تتطلب وضوحاً أكبر في وجهة هذا الإنفاق والقطاعات التي استفادت منه. ومع عدم وجود تدفق استثماري يغطي كامل النفقات الرأسمالية، يصبح الاقتراض ضرورة اقتصادية وليس خيارًا ترفيهيًا، شرط أن يُدار بكفاءة.
الملاحظة الثالثة، أن تنويع أدوات الدين مهم وسيساهم بتخفيف تكلفة خدمة الالتزامات المالية. حيث تم تسديد سندات اليوروبوند المستحقة عبر تمويل ميسر من بعض الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى إصدار أدوات مالية جديدة مثل الصكوك الإسلامية لاستثمار فائض السيولة لدى البنوك الإسلامية وتوفير بدائل تمويلية منخفضة الفائدة. هذه الخطوات تساعد على استدامة الدين وتحسين إدارة الالتزامات المالية الحكومية.
تحليل أرقام المالية العامة يظهر صورة قد تبدو مختلفة قليلةً، من حيث الالتزام بعدة محاور رئيسية: أولًا، ضبط النفقات الجارية حيث سجلت زيادة منخفضة حوالي 6%، وهو مؤشر إيجابي على السيطرة المالية؛ ثانيًا، تحفيز النمو الاقتصادي، إذ أظهرت الأرقام نموًا نسبيًا بلغ 2.7% في الربع الأول و2.8% في الربع الثاني نتيجة سلسلة قرارات تحفيزية انعكست على زيادة الإيرادات وتقليل العجز؛ ثالثًا، تنويع أدوات الدين لتقليل تكلفة التمويل وتحسين الإدارة المالية. واذا ما استمر هذا السياق في إدارة الدين سينعكس بصورة ايجابية على خفض مستوياته كنسبة من الناتج حتى إن أظهر ارتفاعاً مؤقتاً بفترة من الفترات.
مرة أخرى نؤكد على أن الدين العام ليس مشكلة بحد ذاته إذا ما تم استخدامه وفقاً للأس العلمية وضمن منهجية محكمة تركزعلى تحفيز النمو الاقتصادي وتراعي مبادىء الاستدامة المالية، لكن غياب الشفافية والاستراتيجية الواضحة هو ما يثير القلق. فالاقتراض أداة اقتصادية ضرورية في ظل اختلالات الاقتصاد الإقليمي والعالمي، شرط أن يُدار بذكاء لتحقيق أهداف محددة: دعم النمو، تحسين الكفاءة، وضمان الاستدامة المالية. فالفرق كبير وجوهري هو بين من يقترض لتعزيز إدارة الإنفاق والنمو، ومن يقترض بلا رؤية لتغطية النفقات الجارية وخدمة الدين.
إن الفهم الاقتصادي المتكامل للدين العام هو الركن الأساسي في المعادلة، والذي يأخذ في الاعتبار النمو، الكفاءة، والاستدامة، لذلك هو الخطوة الأساسية للحكم العادل على السياسات المالية. الأرقام وحدها لا تكفي، بل يجب النظر إلى ما وراءها: كيف يُدار الدين؟ هل يساهم في التنمية الاقتصادية؟ وهل يضمن استدامة المالية العامة؟ الخروج من جدلية "من الأكثر اقتراضًا" إلى الحديث عن "فاعلية الاقتراض" هو ما يحتاجه الاقتصاد الأردني اليوم.