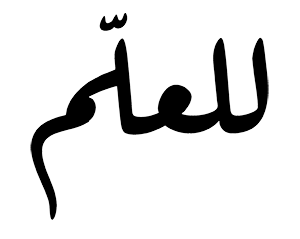خطة ترامب 2025: سلام على الورق أم استسلام على الأرض؟
منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خطته الأخيرة بشأن غزة في سبتمبر 2025، انقسمت الآراء حول ماهيتها: هل هي مبادرة جادة للسلام، أم أنها صيغة جديدة لاستسلام مشروط؟ السؤال ليس ترفًا سياسيًا، بل هو جوهر فهم المرحلة المقبلة في أخطر ملف عربي ودولي.
الخطة وُصفت بأنها “خطة من عشرين نقطة” تنص على وقف إطلاق النار، وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، وإدارة انتقالية لغزة تحت إشراف دولي، تقودها لجنة تكنوقراطية فلسطينية، على أن يُعاد إعمار القطاع بتمويلات دولية سخية. على الورق، يبدو أن الحديث عن إعمار ووقف للقتال يُقارب لغة الحلول. لكن عند التمعن في التفاصيل، نجد أن أساس الخطة يقوم على شرط واحد: نزع سلاح المقاومة وتفكيك بنيتها الأمنية والعسكرية، مع إقصائها الكامل عن أي دور سياسي في مستقبل غزة.
هذا البند وحده يكفي لوضع الخطة في خانة “الاستسلام”. فحين يُطلب من طرف يعيش تحت الاحتلال والحصار أن يتخلى عن آخر أدوات قوته قبل أن تُمنح له أي ضمانات سياسية أو سيادية، فإننا أمام فرض إملاءات لا أمام عملية سلام متكافئة. السلام الحقيقي لا يطلب من شعب أعزل أن يسلم سلاحه ليجلس على طاولة بلا أوراق، بل يضمن له على الأقل حقه في تقرير مصيره وحماية أرضه.
الأخطر أن الخطة لا تُعيد للفلسطينيين سيادتهم الكاملة على القطاع، بل تنص على إدارة انتقالية تحت وصاية دولية تُسمى “مجلس السلام”، يرأسه ترامب نفسه وأسماء من شخصيات دولية. بهذا تصبح غزة تحت حكم خارجي مموه، لا دولة حقيقية ولا سلطة وطنية كاملة. أي أنها تُسلَّم من يدٍ إلى يد، بينما تبقى القوة الأمنية والقدرة على التدخل بيد إسرائيل ومن يقف وراءها.
أما بند الانسحاب الإسرائيلي، فهو مشروط ومقيد بمدى الالتزام الفلسطيني بتفكيك السلاح. أي أن الاحتلال يحتفظ بمفتاح العودة متى شاء، ويظل صاحب اليد العليا في ضبط إيقاع “الانسحاب التدريجي”. على هذا النحو، تتحول الخطة إلى لعبة مشروطة: كلما تخلى الفلسطينيون عن أداة من أدواتهم، مُنحوا وعدًا بفتح معبر أو إدخال بعض المواد أو السماح بمشروع إعمار. هذه ليست معادلة سلام، بل معادلة تسليم.
كذلك تُقدَّم وعود اقتصادية ضخمة: مليارات للاستثمار، مشاريع بنية تحتية، فرص عمل، وإعمار شامل. لكن السؤال الأهم: بأي ثمن؟ إذا كان الثمن هو التخلي عن الحقوق السياسية الأساسية، فإن الأموال تتحول إلى رشوة سياسية لتجميل الاستسلام. التاريخ القريب علّم الفلسطينيين أن وعود الإعمار كانت في كثير من الأحيان ورقة ضغط، تتأخر أو تُمنع أو تُجزأ وفقاً لمصالح الطرف المسيطر على المعابر.
خطة ترامب 2025، بهذا المعنى، ليست بعيدة عن “صفقة القرن” التي سبقتها في 2020، بل هي امتداد لها بصيغة أكثر مباشرة. كلاهما يقوم على المبدأ نفسه: فرض شروط المنتصر على المهزوم، تغليفها بخطاب اقتصادي وتنموي، مع إغفال جوهر القضية وهو حق الفلسطينيين في أرضهم، وحق اللاجئين في العودة، وحق الشعب في دولة ذات سيادة.
السلام، إذا كان صادقًا، يقوم على الاعتراف بالحقوق، لا على تصفية الحقوق. يقوم على ضمانات قانونية وسياسية متوازنة، لا على وصاية دولية تُعيد إنتاج الاحتلال بصيغة أخرى. لذلك، فإن خطة ترامب الأخيرة تبدو كوثيقة استسلام أكثر منها وثيقة سلام: استسلام يُفرض على شعب لم يُهزم عسكريًا، بل صمد رغم الحصار والدمار، ويُراد له أن يُجرد من روحه السياسية مقابل وعود تنموية.
يبقى السؤال: هل ستنجح الخطة؟ التاريخ يُجيب بأن أي مبادرة لا تراعي العدالة ولا تعترف بالحق ستسقط، مهما زخرفتها البيانات الدولية. فغزة لم تصمد عقودًا لتستسلم بورقة تفاوضية. الشعوب قد تُرهق لكنها لا تُسلّم. وما بين سلام حقيقي واستسلام مقنّع، يظل الفارق واضحًا: السلام يحفظ الكرامة، أما الاستسلام فيلغيها.
الخطة وُصفت بأنها “خطة من عشرين نقطة” تنص على وقف إطلاق النار، وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، وإدارة انتقالية لغزة تحت إشراف دولي، تقودها لجنة تكنوقراطية فلسطينية، على أن يُعاد إعمار القطاع بتمويلات دولية سخية. على الورق، يبدو أن الحديث عن إعمار ووقف للقتال يُقارب لغة الحلول. لكن عند التمعن في التفاصيل، نجد أن أساس الخطة يقوم على شرط واحد: نزع سلاح المقاومة وتفكيك بنيتها الأمنية والعسكرية، مع إقصائها الكامل عن أي دور سياسي في مستقبل غزة.
هذا البند وحده يكفي لوضع الخطة في خانة “الاستسلام”. فحين يُطلب من طرف يعيش تحت الاحتلال والحصار أن يتخلى عن آخر أدوات قوته قبل أن تُمنح له أي ضمانات سياسية أو سيادية، فإننا أمام فرض إملاءات لا أمام عملية سلام متكافئة. السلام الحقيقي لا يطلب من شعب أعزل أن يسلم سلاحه ليجلس على طاولة بلا أوراق، بل يضمن له على الأقل حقه في تقرير مصيره وحماية أرضه.
الأخطر أن الخطة لا تُعيد للفلسطينيين سيادتهم الكاملة على القطاع، بل تنص على إدارة انتقالية تحت وصاية دولية تُسمى “مجلس السلام”، يرأسه ترامب نفسه وأسماء من شخصيات دولية. بهذا تصبح غزة تحت حكم خارجي مموه، لا دولة حقيقية ولا سلطة وطنية كاملة. أي أنها تُسلَّم من يدٍ إلى يد، بينما تبقى القوة الأمنية والقدرة على التدخل بيد إسرائيل ومن يقف وراءها.
أما بند الانسحاب الإسرائيلي، فهو مشروط ومقيد بمدى الالتزام الفلسطيني بتفكيك السلاح. أي أن الاحتلال يحتفظ بمفتاح العودة متى شاء، ويظل صاحب اليد العليا في ضبط إيقاع “الانسحاب التدريجي”. على هذا النحو، تتحول الخطة إلى لعبة مشروطة: كلما تخلى الفلسطينيون عن أداة من أدواتهم، مُنحوا وعدًا بفتح معبر أو إدخال بعض المواد أو السماح بمشروع إعمار. هذه ليست معادلة سلام، بل معادلة تسليم.
كذلك تُقدَّم وعود اقتصادية ضخمة: مليارات للاستثمار، مشاريع بنية تحتية، فرص عمل، وإعمار شامل. لكن السؤال الأهم: بأي ثمن؟ إذا كان الثمن هو التخلي عن الحقوق السياسية الأساسية، فإن الأموال تتحول إلى رشوة سياسية لتجميل الاستسلام. التاريخ القريب علّم الفلسطينيين أن وعود الإعمار كانت في كثير من الأحيان ورقة ضغط، تتأخر أو تُمنع أو تُجزأ وفقاً لمصالح الطرف المسيطر على المعابر.
خطة ترامب 2025، بهذا المعنى، ليست بعيدة عن “صفقة القرن” التي سبقتها في 2020، بل هي امتداد لها بصيغة أكثر مباشرة. كلاهما يقوم على المبدأ نفسه: فرض شروط المنتصر على المهزوم، تغليفها بخطاب اقتصادي وتنموي، مع إغفال جوهر القضية وهو حق الفلسطينيين في أرضهم، وحق اللاجئين في العودة، وحق الشعب في دولة ذات سيادة.
السلام، إذا كان صادقًا، يقوم على الاعتراف بالحقوق، لا على تصفية الحقوق. يقوم على ضمانات قانونية وسياسية متوازنة، لا على وصاية دولية تُعيد إنتاج الاحتلال بصيغة أخرى. لذلك، فإن خطة ترامب الأخيرة تبدو كوثيقة استسلام أكثر منها وثيقة سلام: استسلام يُفرض على شعب لم يُهزم عسكريًا، بل صمد رغم الحصار والدمار، ويُراد له أن يُجرد من روحه السياسية مقابل وعود تنموية.
يبقى السؤال: هل ستنجح الخطة؟ التاريخ يُجيب بأن أي مبادرة لا تراعي العدالة ولا تعترف بالحق ستسقط، مهما زخرفتها البيانات الدولية. فغزة لم تصمد عقودًا لتستسلم بورقة تفاوضية. الشعوب قد تُرهق لكنها لا تُسلّم. وما بين سلام حقيقي واستسلام مقنّع، يظل الفارق واضحًا: السلام يحفظ الكرامة، أما الاستسلام فيلغيها.