يثير مهرجان جرش، منذ انطلاقه عام 1981، أسئلة متكررة حول مكانة الفعل الثقافي في الحياة العامة، وعلاقته بالمجتمع المحلي من جهة، وبالخطاب السياسي والأيديولوجي من جهة أخرى. وفي كل عام، ومع كل دورة جديدة، تتجدد الاعتراضات على إقامة المهرجان، وتتكرر ذات الحجج تقريبًا: «كيف يُعزف في جرش وغزة تنزف؟»، «كيف نغني وهناك بلد عربي ينزف دمًا؟».
لكن السؤال الحقيقي ليس هنا، بل في هذا الربط القسري بين الفنون والمآسي، وكأن الغناء خيانة، وكأن الشعر فعل لا أخلاقي، وكأن لا يليق بأمة جريحة.
منذ عودة مهرجان جرش في 2011 بعد انقطاعه، والمنطقة العربية لم تهدأ؛ فالحروب والأزمات ممتدة من العراق إلى سوريا، ومن اليمن إلى ليبيا، وفلسطين نزيف لا يتوقف. فهل صار شرط إلقاء قصيدة أو إقامة عرض مسرحي أو غناء أغنية، أن لا يكون هناك جريح عربي واحد؟ وهل يعقل أن تصبح الثقافة فعلاً مؤجلاً بانتظار زوال الألم، في منطقة لم تتعافَ منذ عقود؟
هذا الألم الكبير في غزة، الذي يوجعنا في كل لحظة، ويحطم معنوياتنا ونفسياتنا، لا يشكّل الفن والموسيقى والغناء نقيضًا له، بل إعلان حياة متجدد، تهديه جرش للمكلومين هناك، لتقول لهم: رغم كل ما تعيشونه من مأساة غير مسبوقة في التاريخ، فسيكون لديكم يوماً ما ما تحتفلون به، وما تغنّون من أجله.
إنه نوع من شدّ الأزر، بأدوات تحيي الأمل في حياة جديدة قادمة. نحن نغني من أجلكم؛ قلوبنا تعتصر ألماً، لذلك سنغني كي يقف الموت، من أجل حياة لا قتل فيها... قريبًا. لأننا لا نستطيع إلغاء الألم من الحياة، لكننا نستطيع أن نجعله قابلاً للتعبير، للغناء، للرسم، للكتابة، للتأمل. بهذا فقط، يتحوّل الحزن من لعنة ثقيلة إلى لحظة وعي، بل إلى جسر عبور نحو الشفاء.
إن أخطر ما في هذا المنطق الرافض للثقافة أنه يحوّل الفنون إلى فعل غير أخلاقي بالضرورة، يخدش هيبة الموت، ويسيء إلى الشهادة، وينافي الاحترام للمصاب العربي. بل تُحمَّل الثقافة مسؤولية الترف، واللاجدوى، واللامبالاة، وهي تهم أخلاقية في ظاهرها، لكنها أيديولوجية في جوهرها.
المفارقة أن الجهات التي تعترض على المهرجانات والفعاليات الفنية اليوم، هي نفسها التي اعترضت قبل عقود على حفلات موسيقية وعروض ترفيهية لأسباب مشابهة، لكنها كانت دائماً تستند إلى موقف ايدولوجي، لا إلى سياق سياسي.
كل هذه الاعتراضات في دلالتها؛ لا علاقة لها بفلسطين أو الاحتلال، بقدر ما تعكس العداء المتجذر للفن والترفيه في تصور بعض التيارات، بوصفها «مجونًا»، أو «لهوًا»، حسب بعض التعابير المتكررة في أدبياتهم.
العداء للفنون هنا ليس طارئاً ولا وليد لحظة سياسية، بل موقف أيديولوجي راسخ. ولذا فإن التذرع بغزة، أو غيرها، ليس إلا واجهة لتبرير هذا العداء، وإلباسه لبوساً أخلاقياً.
لكن الواقع يؤكد أن الثقافة والفنون لم تكن في يوم من الأيام على الضفة المقابلة للمقاومة، بل كانت رديفاً حقيقياً لها في تجارب الشعوب التي واجهت الاستعمار والطغيان. المقاومة ليست فقط بالبندقية، بل بالكلمة، بالصورة، بالدراما، بالموسيقى.
والمحتل نفسه، الذي نناهضه، بنى ترسانة ثقافية وترفيهية ضخمة، أسهمت في ترسيخ وعيه الذاتي وتعزيز اقتصاده ومجتمعه. لم تكن مهرجانات الغناء في تل أبيب سببًا لهزيمة إسرائيل، بل بقيت منطقتنا، رغم كل «طهارتها الأخلاقية»، هي المهزومة دوماً.
في الأردن، كما في العالم العربي، الفنون لا تزال تعامل كترف زائد، لا كرافعة تنموية أو قوة ناعمة. وما يزيد الطين بلّة، أن الأنظمة التعليمية تهمّش الموسيقى والمسرح والفنون البصرية، وتعاملها بوصفها «أنشطة لا صفّية» لا تُقيم بناء الإنسان، بل تلهيه.
وتتشكل نظرة مجتمعية معادية للثقافة، باعتبارها مدخلاً للتسيب أو التشكيك، لا للتنوير والنقد والبناء. هذه النظرة هي ما يحرم الفعل الثقافي من الحاضنة الاجتماعية، ويجعله غريباً في محيطه، لا يجد له جذوراً في وعي الناس ولا في تفاصيل يومهم.
ما نحتاجه اليوم ليس فقط الدفاع عن مهرجان جرش كفعالية قائمة، بل إعادة طرح الثقافة والفنون كحق مجتمعي، وضرورة وطنية، لا مجرد استعراض سياحي موسمي.
الرهان ليس على الفعاليات بذاتها، بل على إيمان عميق بدور الفنون في صناعة الوعي، ومقاومة القبح، وتعزيز الهوية، والدفاع عن الحق.
إن مجتمعات لا تحتفي بالجمال، لا يمكن أن تنتصر للحرية. ومجتمعات تستهجن الغناء، وتخجل من الرقص، وتخاف من القصيدة، لن تتمكن من كسر القيود، ولا من مقاومة القهر.
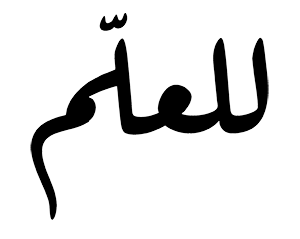
التعليقات