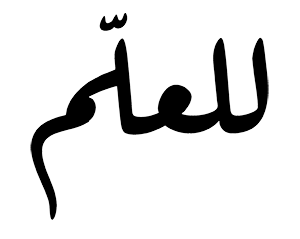وحش الاستهلاك وضربته القادمة .. وما بوسعنا أن نفعله؟
انفلتت النزعة الاستهلاكية لحدود غير مسبوقة مع بداية التسعينيات من القرن الماضي، حيث أتى انهيار الكتلة الشيوعية ليدشن عصرًا يقوم على الاستهلاك المفرط وعلى وعود بتحقيق الرفاهية لأكبر عدد من الناس، وبدأت العديد من الظواهر تغزو المنطقة العربية مندفعة بالتغيرات السلوكية في الغرب.
تزامن مع ذلك الصعود الصيني وتزايد معدلات التصنيع في شرق وجنوب آسيا بشكل عام، الأمر الذي أدى توفر السلع الرخيصة، وفي المقابل تراجعت الصناعات المحلية، ويمكن أن نستدعي محليًا تجربة شركة الأجواخ الأردنية وجودة منتجاتها وعدم قدرتها لاحقًا في منافسة البضائع المستوردة، وكان للتغير السلوكي دوره في ذلك، فاقتناء قطعة ملابس من الشركة كان يعادل أربع قطع مستوردة، والمواطن الأردني، مثل غيره حول العالم، لم يعد مكتفيًا بمجموعة قليلة من قطع الملابس، ويسعى إلى التغيير الدائم، والبدائل متوفرة بأسعار رخيصة، وهو لا يقوم بالحسابات اللازمة بين الجودة والمظهر.
ومع بداية الألفية الجديدة، أضيفت أعباء تكنولوجيا المعلومات والاتصال على جيوب المستهلكين، وأصبحت فواتير الهواتف الخلوية واشتراكات الإنترنت تتنافس مع احتياجات أساسية لدى المستهلكين.
فورة الاستهلاك كانت تترافق مع عملية إعادة توزيع للدخول والثروات على المستوى العالمي، فالأموال خرجت من الأسواق المحلية، ومعها فرص التشغيل والمساهمة الاقتصادية لتحط في بنايات زجاجية في نيويورك أو بكين، وكان على الغارقين في فخاخ الاستهلاك أن يقترضوا من أجل تغذية متطلباتهم.
يشهد العالم تحولًا عن الاستهلاك المفرط بوصفه نموذجًا غير قابل للإستدامة، وعصر السلع الرخيصة يكاد يلملم أوراقه، والعيش ضمن نفس الأنماط الاستهلاكية سيتسبب في الإرهاق المالي للأفراد وحتى الدول، وصولًا إلى الفشل، ولكن من يقرع الجرس في هذه الحالة؟.
هل يقوم الإعلام الذي تعتبر المواد الدعائية والإعلانية أحد موارده الأساسية بهذه الأدوار؟ إلى حد ما يمكنه أن يفتح منصاته لأشخاص يحذرون من ثقافة الاستهلاك، ولكنه لن يغلق الأبواب أمام الإعلانات التي تطرح النزوات الاستهلاك بأفضل صورة ممكنة، وتحاول أن تذكر الأفراد باحتياجات ليست أساسية، ثم أن مواقع التواصل الاجتماعي استولت على بناء الصورة الذهنية للأشخاص وجعلت الاستهلاك أو القدرة على الاستهلاك على رأس أجندتها، والتسلل النفسي في هذه المواقع من المكر والاتقان بحيث يصعب تتبعه أو كشفه، ولو انكشف بالنسبة للناضجين نسبيًا، فهو يحول الضغوطات الخاصة بالنزعة الاستهلاكية للمراهقين والأطفال الذين أخذوا يمتلكون كلمة أعلى نسبيًا في قرارات أي منزل قياسًا بالأزمنة الماضية.
لا يمكن حصر مصادر القلق والتوتر في الحياة المعاصرة بتراجع الظروف الاقتصادية، فالواقع ان هذه نتيجة للنزعة الاستهلاكية، وأبرز صورها بطبيعة الحال ارتفاع تكلفة المعيشة مندفعة باستهلاك غير رشيد على المستوى الفردي، والظاهرة عالمية إلى حد بعيد، فالتضخم يفرض نفسه على أرفف المنتجات الأساسية وغير الأساسية في العالم كله.
يبدو أنه من الضروري على الحكومات في هذه المرحلة، ولأسباب اجتماعية قبل الاقتصادية، أن تخوض في حملات للتوعية بالاستهلاك المنطقي والرشيد، لأن الظروف لن تتحسن بالصورة المطلوبة، وتحقيق الأحلام (الأوهام في جوهرها، على المستوى الفردي والجماعي) أصبح مكلفًا للغاية، وربما عليها أن تعيد جدولة سياسات التحفيز لبناء سلوك استهلاكي أفضل، وأن تعمل بجانب ذلك إلى تأسيس اقتصاد رحيم بالمعنى الذي يتاح فيه للمواطنين الاستمتاع بحدود معقولة من جودة الحياة مثل الحدائق والمتنزهات بدلًا من محاولة صناعة النموذج الشخصي الذي يسعى له الجميع، ويتزاحمون من أجل تحقيقه، ويخرجون جميعًا، عاجلًا أم آجلًا، خاسرين من تراكضهم الاستهلاكي.
ليست دعوة للتشاؤم بقدر ما هي متطلب ضروري لتجنب صدمات مستقبلية ستتخذ جوانب اجتماعية متعددة المستويات، وحتى لو كان تجنبها غير ممكن، فعلى الأقل، فمن الضروري التخفيف من أثر صدمة تراجع القدرة على الاستهلاك.
انفلتت النزعة الاستهلاكية لحدود غير مسبوقة مع بداية التسعينيات من القرن الماضي، حيث أتى انهيار الكتلة الشيوعية ليدشن عصرًا يقوم على الاستهلاك المفرط وعلى وعود بتحقيق الرفاهية لأكبر عدد من الناس، وبدأت العديد من الظواهر تغزو المنطقة العربية مندفعة بالتغيرات السلوكية في الغرب.
تزامن مع ذلك الصعود الصيني وتزايد معدلات التصنيع في شرق وجنوب آسيا بشكل عام، الأمر الذي أدى توفر السلع الرخيصة، وفي المقابل تراجعت الصناعات المحلية، ويمكن أن نستدعي محليًا تجربة شركة الأجواخ الأردنية وجودة منتجاتها وعدم قدرتها لاحقًا في منافسة البضائع المستوردة، وكان للتغير السلوكي دوره في ذلك، فاقتناء قطعة ملابس من الشركة كان يعادل أربع قطع مستوردة، والمواطن الأردني، مثل غيره حول العالم، لم يعد مكتفيًا بمجموعة قليلة من قطع الملابس، ويسعى إلى التغيير الدائم، والبدائل متوفرة بأسعار رخيصة، وهو لا يقوم بالحسابات اللازمة بين الجودة والمظهر.
ومع بداية الألفية الجديدة، أضيفت أعباء تكنولوجيا المعلومات والاتصال على جيوب المستهلكين، وأصبحت فواتير الهواتف الخلوية واشتراكات الإنترنت تتنافس مع احتياجات أساسية لدى المستهلكين.
فورة الاستهلاك كانت تترافق مع عملية إعادة توزيع للدخول والثروات على المستوى العالمي، فالأموال خرجت من الأسواق المحلية، ومعها فرص التشغيل والمساهمة الاقتصادية لتحط في بنايات زجاجية في نيويورك أو بكين، وكان على الغارقين في فخاخ الاستهلاك أن يقترضوا من أجل تغذية متطلباتهم.
يشهد العالم تحولًا عن الاستهلاك المفرط بوصفه نموذجًا غير قابل للإستدامة، وعصر السلع الرخيصة يكاد يلملم أوراقه، والعيش ضمن نفس الأنماط الاستهلاكية سيتسبب في الإرهاق المالي للأفراد وحتى الدول، وصولًا إلى الفشل، ولكن من يقرع الجرس في هذه الحالة؟.
هل يقوم الإعلام الذي تعتبر المواد الدعائية والإعلانية أحد موارده الأساسية بهذه الأدوار؟ إلى حد ما يمكنه أن يفتح منصاته لأشخاص يحذرون من ثقافة الاستهلاك، ولكنه لن يغلق الأبواب أمام الإعلانات التي تطرح النزوات الاستهلاك بأفضل صورة ممكنة، وتحاول أن تذكر الأفراد باحتياجات ليست أساسية، ثم أن مواقع التواصل الاجتماعي استولت على بناء الصورة الذهنية للأشخاص وجعلت الاستهلاك أو القدرة على الاستهلاك على رأس أجندتها، والتسلل النفسي في هذه المواقع من المكر والاتقان بحيث يصعب تتبعه أو كشفه، ولو انكشف بالنسبة للناضجين نسبيًا، فهو يحول الضغوطات الخاصة بالنزعة الاستهلاكية للمراهقين والأطفال الذين أخذوا يمتلكون كلمة أعلى نسبيًا في قرارات أي منزل قياسًا بالأزمنة الماضية.
لا يمكن حصر مصادر القلق والتوتر في الحياة المعاصرة بتراجع الظروف الاقتصادية، فالواقع ان هذه نتيجة للنزعة الاستهلاكية، وأبرز صورها بطبيعة الحال ارتفاع تكلفة المعيشة مندفعة باستهلاك غير رشيد على المستوى الفردي، والظاهرة عالمية إلى حد بعيد، فالتضخم يفرض نفسه على أرفف المنتجات الأساسية وغير الأساسية في العالم كله.
يبدو أنه من الضروري على الحكومات في هذه المرحلة، ولأسباب اجتماعية قبل الاقتصادية، أن تخوض في حملات للتوعية بالاستهلاك المنطقي والرشيد، لأن الظروف لن تتحسن بالصورة المطلوبة، وتحقيق الأحلام (الأوهام في جوهرها، على المستوى الفردي والجماعي) أصبح مكلفًا للغاية، وربما عليها أن تعيد جدولة سياسات التحفيز لبناء سلوك استهلاكي أفضل، وأن تعمل بجانب ذلك إلى تأسيس اقتصاد رحيم بالمعنى الذي يتاح فيه للمواطنين الاستمتاع بحدود معقولة من جودة الحياة مثل الحدائق والمتنزهات بدلًا من محاولة صناعة النموذج الشخصي الذي يسعى له الجميع، ويتزاحمون من أجل تحقيقه، ويخرجون جميعًا، عاجلًا أم آجلًا، خاسرين من تراكضهم الاستهلاكي.
ليست دعوة للتشاؤم بقدر ما هي متطلب ضروري لتجنب صدمات مستقبلية ستتخذ جوانب اجتماعية متعددة المستويات، وحتى لو كان تجنبها غير ممكن، فعلى الأقل، فمن الضروري التخفيف من أثر صدمة تراجع القدرة على الاستهلاك.